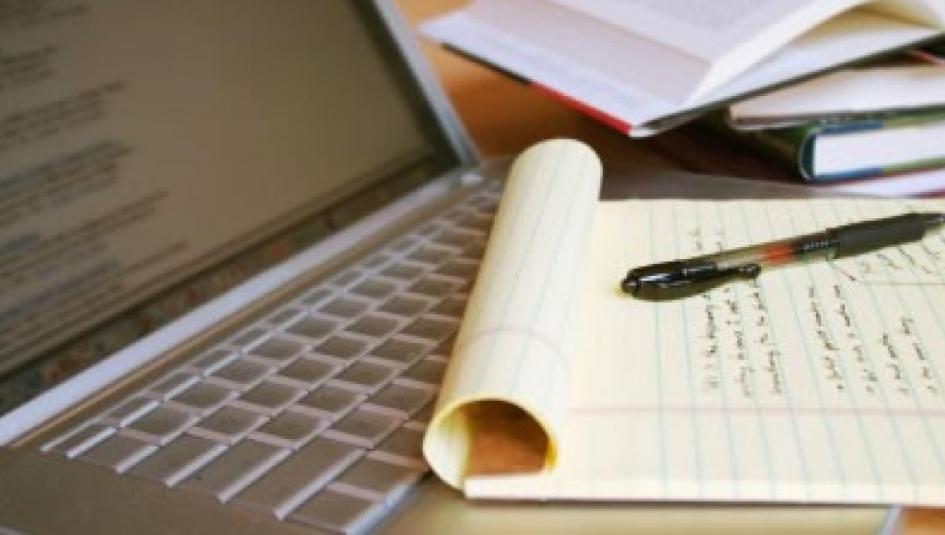يلعب التعليم واقتصادياته الدور الأساس في نهضة الأمم وتحقيق تنميتها الاقتصادية، بل وإنني اعتبر أن بوابة التنمية هي بوابة المدرسة الابتدائية والتعليم الأساسي؛ وذلك لأهمية التعليم في نزع الجهل وزيادة قدرة الأفراد على الانخراط في الإنتاج، وزيادة قدرتهم على رفع مستواهم الصحي مما يعزز رفاه المجتمعات، وليس ذلك فقط، بالطبع أيضا لقدرة المنظومة التعليمية الرائدة على صياغة القيم والمفاهيم المجتمعية والوطنية القادرة على زيادة تجانس الأمم وتشكيلها كأمة بعيدا عن النزاعات والعنصريات والتمييز، حتى وان كانت متباينة في جوانب عدة، وهذا ما نجحت فيه الكثير من الأمم وبطرق متعددة ولكن دوما وبالأساس عبر نظامها التعليمي مما يوفر عليها ثمن الصراع والحروب الأهلية.
وهنا يأتي الدور الأساس للحكومة كإطار تنفيذي مؤقت ومنتخب يعبر عن الدولة والأمة وما يمثلها من قيم وتراث وعقائد متجذرة لتنفق من اجل رفع مستوى البنى الاجتماعية كالتعليم والصحة كما البنى المادية من مطارات وطرق ومنظومات مياه ..الخ وذلك لرفع الإنتاج الذي بدوره سيزيد الإنفاق على التعليم والصحة ليعود بأثره مرة أخرى على الإنتاج، كم تؤكد اقتصاديات التنمية.
إذن فالتعليم والسياسات العامة حوله آثار قيمية ومادية لا تسمو منظومة التعليم إلا بتحقيقها على الوجه الأمثل.
ومن هنا يأتي دور النظر في المنظومة التعليمية الفلسطينية التي تعيد تكرار صياغة أدوات تحصيل جنودها معرفيا بشكل مرهق شديد الزخم على الرغم من تكرار الإخفاقات الملحوظ، واقصد هنا التركيز على الحشو العلمي والمعرفي والتركيز الزائد على مراكمة وتعقيد المعارف، وقد نوافق على جدوى هذا الأمر في ظروف مختلفة، أما إذا كان الإنفاق على البنى المادية من مدارس ومختبرات ناقص ومتدني ومتراجع خصوصا مقارنة بأوجهه أخرى اقل أولوية للمجتمعات الحرة، وكذلك الرقابة على الأداء الفني والعلمي وإعداد الكفاءات علميا ونفسيا وسلوكيا والرقابة عليها، ومن ناحية أخرى المكابرة في فلسفة الترفيع الآلي للغير قادرين وعدم وجود رؤية وبنية لاستيعابهم في مجالات تقنية ومهنية.
ومن ناحية ثالثة والاهم أين هو الأثر على الجانب القيمي الذي يجب أن تصيغه المؤسسة العامة والرؤية الكلية للمجتمع والأمة، فتجد أن تأثير الجزء أي الحزب والعشيرة والأسرة والشارع اقوي من تأثر المنظومة ككل لانعدام أثرها. وبشكل أوضح دعني أتساءل، أين هو النظام والسلوك والترتيب والتفاهم والذوق الرفيع وإعمال العقل بعمق والإيثار والتفكير التقدي والبناء والعمل الجماعي وتفهم الآخر والحفاظ على الممتلكات العامة لدى الاجيال الناشئة على تعاقبها، وهذه مؤشرات فوقية ظاهرية للإيضاح، بل إن هناك قيما أساسية يجب العمل عليها، فأين هو المغزى الحقيقي من المنظومة وسياساتها.
وهذا يدلل على إخفاق حقيقي في جانب التحصيل المعرفي كما في جانب الانجاز القيمي. ففي برنامج وثائقي للــ BBC الذي ناقش سلوك العمال الألمان وجد أن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث مع زملاء العمل أو التظاهر بالعمل أثناء مرور رئيسك تعتبر سلوكيات غير مقبولة اجتماعيًا. وهذه التصرفات مرفوضة من المديرين حول العالم إلا أنها غير مقبولة من العمال أنفسهم ومنبوذة اجتماعيا، مما يدلل على اثر المعايير الثقافية والتعليم على الإنتاج.
ومن قبل هذا كله وبعده ، أين آليات ومعايير وبنى استكشاف قدرات ورغبات وإبداعات أبنائنا سواء ضمن المنظومة الرسمية أو المرافقة، أين استكشافنا وتنميتنا لذوي القدرات الإبداعية أو الرياضية أو الفنية أو الأدبية الخ، فلا نحن نعرفهم ولا هم يعرفون أنفسهم، علما أن موسيقي مبدع أو لاعب كرة قدم قد يدر أكثر من قطاع اقتصادي بأكمله.
ثم نهزم أبنائنا شر هزيمة بعام المصير أو التوجيهي الذي يضع الفرد في بوتقة، كما الجني في المصباح، لا فكاك منها مجتمعيا أو رسميا وان بلغ ما بلغ علميا أو مجتمعيا، ولا يعطى فرصة لتنويع خياراته بعد ذلك عبر اختبارات شفهية أو تحريرية أو مسابقات لتفتح أمامه فرصا جديدة. علما أن تفوق بل وبروز العباقرة متكرر الحدوث في مراحل الجامعة والعمل المهني، واستمرار العقلية التلقينية الصماء لمن اعتاد الحفظ دون الفهم حالات متكررة أيضا، ولا ادعوا هنا لعدم اعتبار الحصول على معدلات مرتفعة، وإنما الكف عن وضع القيود المجتمعية والنفسية والمصيرية على أبتائنا وفتح الفرص والآفاق أمامهم ومساعدتهم على الثقة بالنفس واستكشافها.
إن عقلية التلقين والحشو والحفظ دون التركيز على المهارات تنسحب في الشخصية والتفكير حتى وان حمل الدرجات العليا، واذكر شهادة بعض طلبة الطب بان التفوق في الامتحان يعتمد على حفظ اكبر عدد ممكن من أسئلة الاختيار المتعدد من الكتب المخصصة لبعض المساقات.
ثم تأتي المرحلة الجامعية لتحولها السياسات العامة لبازار شهادات من فرط تقتير الأنفاق وتعزيز المسار الجامعي الربحي الخاص، لخلق منافسة شرسة لا تعود إلا بالسلب على الجودة، وذلك على حساب التعليم الجامعي العام الرصين من الجامعات العريقة محليا التي لها دور بارز رفد المجتمع بمقدراته البشرية عند حاجة المجتمع لها وحماية القيم الوطنية في عهد الاحتلال.
كما أن عدم وجود رؤية عامة حول حاجة المجتمع وأولوياته مع الآفة المجتمعية المتوارثة في تقسيم الحياة الجامعية لكليات قمة وقاع تحشر أبنائنا في الاختيار غير المرغوب وتجبر الأهل أيضا على الدفع باتجاه كليات القمة من وجهة النظر المجتمعية حتى وان خالفن رغبة الابن وقدراته.
على الرغم من أن التخصصات التي تعنى بإدارة وصياغة النظام العام وبناءه وتطويره أولى دوما في المراحل الأولى للتنمية لان كل الإبداعات والاختراعات لن تجدي نفعا دون نظام اقتصادي وصناعي كفؤ وفعال يستغل هذه الإبداعات العلمية. وهذه مسؤولية خطيرة في عدم انجاز الأولويات الوطنية بالشكل الحقيقي الفعال.
ومن ناحية أخرى فان تراجع دعم التعليم وتركه لسوق اقتصادي رديء يترك الطلاب دون تحصيل المهارات والكفاءات التي تواكب احتياج السوق والتي تتغير وتتغير أولوياتها عبر الزمن، كما وتفيض مخرجات التعليم العالي عن احتياج السوق كما ونوعا، دون آليات لتصدير هذه العمالة أو إكسابها مهارات السوق المطلوبة إقليميا ودوليا.
لا شك عند أن منظومة تعليمية إبداعية هي الكلمة المفتاحية للبناء الحضاري، بينما النظام التلقيني يقود غالبا إن لم يكن حتما لأثر معاكس. وفي غمرة تمنياتنا بنظام إبداعي نُبقي سيف التوجيهي مسلطا على رقاب أبنائنا مهما بلغوا وكيفما أبدعوا، والسياسات العامة تكبت التعليم العالي لا تدعمه. المنظومة المبدعة هي التي تخلق الطرق التي تحفز وتستكشف وتنمي قدرات أبنائها على تبايناتهم حتى المعاقين منهم، وليس للتلقين والقدرة على الحفظ كثير عبرة.
وقد يكون كلامي هذا مجرد كلمة مفتاحيه للإجابة على سؤال لماذا تتقدم الأمم وتتخلف، بعد عقد من تدريس التنمية الاقتصادية بمختلف الجامعات ولكافة المستويات وصولا للدكتوراه والاطلاع على تجارب الأمم في ذلك ودراستها وتدريسها، لا طريق لكم إلا التعليم.